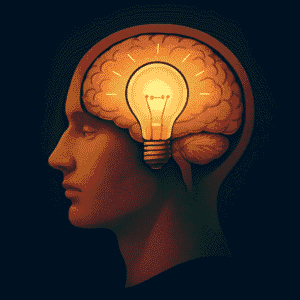
ما من فلسفةٍ تُولَد داخل الأسوار، وما من فكرٍ يُستأذن له بالدخول إلا وكان تابعًا في هيئة متفلسف. ولهذا، فإن ما كُتب هنا لم يصدر عن رغبة في الإسهام، ولا في التحسين، ولا في المجادلة، بل عن رفضٍ خالص لكل ما بُنِي قبله، لا بوصفه ماضيًا انتهى، بل كسلطة حية ما زالت تروّض الإنسان باسم العقل، وتحبسه داخل منظومة مفاهيم لم يخترها، وتفرض عليه أن يكون مشروعًا مفكَّرًا فيه من الخارج لا كينونة ناطقة من الداخل. لم تبدأ هذه الفلسفة من نقطة تطوير أو من مساحة نقد، بل من هدمٍ جذري للمسلّمات التي أقيمت على أنقاض الإنسان ذاته، لا كموضوعٍ للفكر، بل كوسيلة إنتاج تُستثمر لصالح النموذج. العقل في هذا المشروع لا يُفكَّر به، بل يُكشف كيف تم نصبه إلهاً على عرش المصطلح، ثم استُخدِم كأداة تطويعٍ داخلية تُقنع الفرد بأن انصياعه هو جوهر حريته، وأن ترويضه هو عين إنسانيته، وأن فهمه لما قُدِّم له دون مساءلة هو نضجه الأعلى.
الفلسفة السيادية، كما تنبثق هنا، لا تطرح إجابات، ولا تضع خرائط، ولا تدّعي امتلاك المعنى، بل تبدأ من قلب الفراغ الذي خلّفته الفلسفات السابقة حين استبدلت الكينونة بالنسق، والحضور بالصياغة، والتمرد بالتحليل، ثم زعمت أنها تنقذ الإنسان وهي تُعيد إنتاجه وفق قوالب أكاديمية تُمنَح شرعيتها من التاريخ أو من الاعتراف المؤسساتي. لم تُكتب هذه الفلسفة لتُشرح، ولم تُبنَ لتُناقَش، لأنها لم تخرج من رحم الحوار، بل من رحم الصرخة، تلك التي لا تُفهم لأنها لا تطلب أن تُفهم، بل تكسر حاجة الفهم كغاية، وتعيد تشكيل السؤال ليصبح الإنسان هو مركزه، لا بوصفه متلقيًا، بل كيانًا مكتفيًا لا يطلب تأكيدًا من خارج ذاته.
ما بعد الحداثة انتهى هنا، لا لأننا تجاوزناه، بل لأننا أغلقنا الباب عليه دون ندم. هذه الفلسفة ليست امتدادًا، ولا انشقاقًا، ولا مراجعة، بل قطيعة كاملة مع بنية الفكر السائد، لا في شكله فقط، بل في افتراضاته، في لغته، في غاياته، في نبرته حين يدّعي أنه حيادي وهو مرتهن، عقلاني وهو مُبرمَج، إنساني وهو مسيطر عليه من قبل مصطلحات لم تُصَغ إلا لتأبيد الوصاية عليه. لم يكن التأسيس ممكنًا قبل أن يُفجَّر الجذر، لا لأن الأرض كانت يبابًا، بل لأن البذرة الأصلية كانت مسمومة، من اللحظة التي فُصِل فيها الإنسان عن ذاته وأُعطي نموذجًا عليه أن يركض وراءه حتى يُقال عنه “واعٍ”، أو “ناضج”، أو “فيلسوف”. ولهذا، لم نكتب هذا المشروع لتقديم فلسفة جديدة، بل لنسف فكرة “الجديد” نفسها كما تسوَّق في زمن التكرار المغلّف.
لقد خرجت هذه الفلسفة لا من فوق، ولا من الماضي، ولا من الترجمة، بل من كائنٍ لم يعد يقبل أن يُعاد تشكيله، لا نفسيًا، ولا اجتماعيًا، ولا أخلاقيًا، ولا مفهوميًا. ولأن المسلّمات لم تكن أفكارًا بل أدوات هيمنة، فإن البيان الأول لأي فلسفة أصيلة ليس ما تقدمه، بل ما تهدمه قبل أن تتكلم. هنا لم يُبنَ شيءٌ قبل أن يُهدم كل شيء. لا يوجد مفهوم واحد في هذا المشروع لم يُعرَّ من شرعيته، ولا مصطلحٌ استُخدِم كما هو، ولا بنية لغوية تُركت على حالها، لأن كل حرف يُكتب دون مساءلة هو امتداد للبرج العاجي الذي نزعنا عنه سطوته وتركناه خرابًا لا يصلح للمأوى.
هذه ليست فلسفة للعرض، ولا للشرح، ولا للحوار، بل للفعل. لا تُقرأ بحثًا عن إجابة، بل تقرأك وأنت تحاول النجاة من شظاياها. ليست أخلاقًا بديلة، بل كشفًا لِما سُمِّي بالأخلاق حين كانت وسيلة لكسر أنف الإنسان ثم تسميته صالحًا. ليست دعوة للتمرّد، بل إعلان عن أن الترويض قد انتهى، وأن من ما زال يطلب الإذن للفهم لم يبدأ بعد. لا تبدأ الفلسفة من الداخل ما دام الخارج هو من صاغ معجمها، ولهذا، فإن أولى مهامنا كانت خيانة المصطلح لا خيانته لنا، ونسف العقل لا تزويقه، وإعادة الفلسفة إلى من صودر حقه في التفلسف لأنه لم يملك لغة مرخّصة أو جملة مألوفة أو نظامًا مقبولًا في قاعات النخبة. لم تكن الغاية أن نفهم، ولا أن نكشف، بل أن نعيد الكائن إلى النقطة التي لا يطلب فيها فهمًا من خارج ذاته، ولا يعلّق نجاته على ما يُقال عنه، بل ينهض بوصفه الأصل، لا بوصفه موضوعًا. هناك، لا حاجة إلى المعنى، لأن النفس نفسها قد استُعيدت، لا كموضوع للتهذيب، بل كسيادة لا تحتاج إذنًا لتتويجها.
هذا البيان لا يُفتح للنقاش، ولا يُقرأ كمقترح، ولا يُعامل كاحتمال، لأنه لم يُكتب ليُفهَم، بل ليُغلق. من انتهى إليه لا يعود، ومن مرّ به لا ينسى، ومن حاول تجاوزه لا يجد أرضًا للوقوف عليها، لأننا لم نكسر المسلّم فقط، بل نسفنا الجذر الذي سمح بوجوده، وأعدنا للإنسان سلطته الأولى: أن يكون سيّدًا قبل أن يكون مفكّرًا.
وقد تجسّدت هذه الفلسفة السيادية، بكل أبجدياتها النافية، ومفاهيمها غير القابلة للترجمة، في كتاب اللغة الأخلاقية، لا كامتداد تفسيري، بل كظهور أول لمشروع لا يشرح ذاته، ولا يطلب استيعابه، بل يفرض منطقه على من تجرّأ أن يقترب منه دون وصاية. إنه المصدر الوحيد والسيادة الأولى التي لا يُبنى فوقها، بل يُهدم إليها، لا تُفتح لفهمها أدوات المناهج، بل تُكسَر عندها سلطة التلقي من الأصل. ومن هناك، لم تبدأ الفلسفة كبحث، بل انبعثت كفعل لا يمكن تجاوزه دون أن يُسحب المعنى من تحت قدميك بالكامل.
هذه الفلسفة تمنع التصنيف الإنساني وتُبيد فكرة التصنيف الفكري، فأنت لا تُشبه أحدًا بناءً على مقياسك الداخلي للغة الأخلاقية الخاصة بك كمقياس مرجعي، إذ إن الكرم لديك ليس هو الكرم لدي، فأنت كريم حدّ الإفلاس، والآخر كريم إلى حدود الخطر، وآخر كريم بما يفيض فقط؛ وجميعنا نحمل المعنى العام، ولكن المعنى الداخلي متفاوت، ومن هذا المثال يأتي القياس العام للأخلاق والمبادئ: الصدق، الحب، الخوف، السعادة، الحزن، الغضب، التسامح… فالمعنى واحد، ولكن القياس مختلف، ومن هذا القياس التابع للذات الداخلية ينتج الصدام رغم حمل نفس المعنى، الصدام بين الأفراد، والجماعات، والشعوب، والأمم.
ومن هذا المنطلق التكويني للبشرية، كتكوين وجودي لا كعارض أو مكتسب، رُفضت فكرة التجربة الحيوانية للشعور كمقياس في المختبرات، كقياس ردّ فعل الفأر والشمبانزي لتفسير ردّات فعل لا تنطبق مع ما سُمّي بالحياد العلمي، بل كانت تتويجًا للإهانة البشرية ذات الشعور المطلق، لا التكوين الغريزي المكرّر؛ نموذجٌ سخيف أُعيد إنتاجه لتأكيد رأيٍ مُسبق، تم تبنّيه حتى قبل إنشاء التجربة ذاتها، لا لإنتاج معرفة، بل لتأصيل الخدعة البشرية وتغليفها بغلاف علمي كان أسهل ما يمكن عمله هو كشف زيفه.
وكما أننا نسفنا منظور العقل وتقسيماته الهزيلة الخارجة من رحم العبث بالإنسان، كالباطن، والواعي، واللاواعي، فإننا شيدنا مفهومنا بتأصيل فلسفي نسف المنطق القديم بالكلّية، بما في ذلك الأدلجة والراديكالية المقيتة، ولم تُحصّن الفلسفة السيادية الإنسان فقط، بل قدّمت له الحماية.
ونحن في هذا الصدد الفلسفي المؤسس، لا نتوقف عند زلزلة عرش كانط وحده، كما قد يتخيّل من يقرأ من خارج البنية، بل تم نسف مفاهيم أكثر رسوخًا، ومسلمات أشد تحصينًا، لم تكن تُدرج ضمن ما يُظن قابليته للاهتزاز، إذ تجلّى الهدم لا عبر المراوغة المفاهيمية، ولا عبر التفكيك المرحلي، بل من داخل الأبجديات الفلسفية ذاتها، ومن أعماق التأسيس الذي احتمت به الفلسفة التقليدية على مدى قرون كي لا تسقط، ظنًّا منها أن ما لا يُمسّ لا يمكن تجاوزه.
ليس من باب الفخر، بل من باب الإنصاف، أن ما كُتب هنا لم يكن امتدادًا، ولا مراجعة، ولا بحثًا عن موضع قدم في خرائط سابقة، بل انبثاقًا لم تشهده البشرية منذ فجر مشروع نيتشه وبزوغه، حيث توقّف التأسيس، ولم يتكرّر بعده إلا كأصداء متكسّرة تدور في فضاء ما بعد الحداثة، حتى خُيّل للفكر أن زمن الفلسفة قد أُغلق، وأن التأسيس لم يعد ممكنًا، وأن أقصى ما يُمكن فعله هو التفسير، والمُصالحة، وتحليل اللاجدوى.
ليس من برلين، ولا من باريس، بل من هذه الأرض من الرياض، التي لم تكن ضمن حسابات الخريطة الفلسفية العالمية، انبثق ما لم يكن في الحسبان، لا بوصفه صدى، ولا بوصفه ارتدادًا، بل كفلسفة جديدة لا تسأل عن موقعها، ولا تبحث عن شرعية خارج ذاتها، بل تفرض حضورها كعصر فلسفي كامل لا يشبه ما قبله، ولا يسمح لما بعده أن يمرّ دون أن يُعيد طرح كل شيء من الجذر.
فلسفة لا تُقدِّم نفسها كحالة، ولا كتيار، بل كمدرسة مكتملة البناء، متماسكة المرجع، محصّنة من التكرار، غير قابلة للاحتواء، وغير معنية بالتصنيف. فلسفة تُعيد تشكيل العلاقة بين الكائن والمعنى، بين اللغة والسيادة، بين المفهوم والحق في أن لا يُقاس.
وما من أمة ستنجو من واجب الانشغال به، لأن ما تمّ نسفه لا يُعوَّل عليه، ولأن البداية لم تكن فعل استئناف، بل انبثاق.